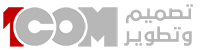تساءل موقع جلوبال ريسك سايتس البريطاني المتخصص في تحليل الأزمات العالمية و التنبؤ بوقوعها عن إمكانية نشوب حرب أهلية جديدة في الجزائر.
وقال الموقع أن التوقعات الاقتصادية القاتمة وسنوات التردي في أسعار البترول تمهد المسرح لاضطرابات شعبية في الجزائر.
وتواجه الدولة تحديات أمنية كبرى، تتضمن تواجد الجماعات الإرهابية، والحدود الهشة التي يسهل اختراقها، وتهديد انتقال الأمراض المعدية من ليبيا ومالي.
هذا التقرير يسلط الضوء على الكيفية التي وصل فيها الوضع في الجزائر إلى نقطة التأزم، وإلى أين تتجه تلك الدولة الشمال إفريقية.
أزمة النفط
تستثمر الجزائر بشكل كبير في صناعة النفط والغاز في أطار جهود لزيادة صادراتها إلى أوروبا.
وتمثل هذه الاستثمارات نحو 97 % من إيرادات الصادرات بالنسبة للجزائر و60 % من موازنة الدولة.
لكن أسعار النفط بدأت في التراجع بالأسواق العالمية مما كان له تداعيات مدمرة.
وفقدت الجزائر 30 % من موازنتها الإجمالية، وفي عام 2015 كانت مضطرة لتنفيذ إجراءات تقشفية للمرة الأولى.
ومن أجل تخفيف وطأة الضربة، قررت الحكومة استخدام الصندووق السيادي الوطني لإحداث توازن في الموازنة.
خاصة أنه بعد مرور عامين إضافيين من أسعار النفط المتهاوية، نضب الصندوق بالكامل.
وتحاول الحكومة الجزائرية كسب الوقت من خلال توقعها في عام 2016 بوجود احتياطي نفطي وغازي جديد.
شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ادعت العثور على 32 منطقة اكتشاف محتملة جديدة.
ومع ذلك، فإن معظم الاكتشافات الجديدة هي حقول غاز صخري تقع في جنوب الجزائر.
يذكر أن استخراج الغاز الصخري يتطلب وفرة من الماء من أجل تنفيذ ما يسمى التجزؤ الهيدروليكي.
وفي دولة مثل الجزائر تقبع تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة، وأحد أكثر المناطق جفافا في العالم، لا يرجح أن يمثل هذا الاكتشاف حلا طويل المدى، خاصة على ضوء انتشار الاحتجاجات.
وفي أفضل السيناريوهات المحتملة، قد تنتج الجزائر الغاز بنفس المعدلات الحالية حتى عام 2030.
ويمنح ذلك للجزائر فترة زمنية تتجاوز قليلا 10 سنوات للعثورعلى موارد بديلة لتمويل 60 % من إيرادات موازنتها.
من أزمة النفط إلى الأزمة الاقتصادية
تحتاج الجزائر بصورة عاجلة إلى تنويع اقتصادها لكنها تواجه عددا من العقبات،هذا الفراغ الذي أصاب الصندوق السيادي الوطني قلص كثيرا من قدرة الجزائر على الاستثمارات الداخلية.
المشروعات الخاصة الجزائرية جرى تهميشها من خلال تركيز الدولة على القطاع النفطي، كما تعاني من نقص المنافسة.
قطاع السياحة الجزائري الذي ينقصه التطوير يوصف بأنه الأولوية رقم 5 بالنسبة للحكومة لكنه ما يزال يتسم بالركود في ظل عدم كفاءة عمليات الترويج، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وفي ذات الأثناء، فإن البيروقراطية المبالغ فيها ونقص التشريعات الداعمة تمثل عقبات رئيسية تقلص الاستثمارات الأجنبية، حتى بالنسبة للمؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وغالبا، ما تتوجه تلك الاستثمارات إلى الجارة المغرب بدلا من الجزائر مثلما فعلت شركة السيارات الفرنسية رينو على سبيل المثال،واكتفت رينو بمصنع صغير في الجزائر لكنها أسست أكبر منشآتها الأجنبية في المغرب.
نفاد الخيارات
أصبح واضحاً على نحو متزايد أن الجزائر تأخرت حتى عن جاراتها فقيرة الموارد، وأن ثروة الدولة تتعرض لسوء إدارة على يد النخبة الحاكمة.
الفضائح التي كشفتها "وثائق بنما" فضحت فسادا واسع النطاق بين الحكومة و"سوناطراك".
الأوضاع الصحية الفقيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جعلت الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للجزائريين من أن السلطة الحقيقية ليست في يده لكنها تتقاسم بين الجيش، وحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، والأجهزة السرية لدائرة الاستعلام والأمن.
وفي واقع الأمر، فإن هذا الأمر تعاني منه الجزائر منذ الاستقلال عام 1962،في البداية، استمدت الحكومة شرعيتها من دورها في حرب الاستقلال.
ومع الصعود في أسعار النفط في الألفية الجديدة، استغلت القوى الحاكمة الإيرادات البترولية لإرضاء الطلبات الشعبية المتنامية المطالبة بالتقدم والتوظيف والحريات الاجتماعية.
وسعت الجزائر إلى تجنب الاضطرابات حينما قامت الحكومة بعملية إعادة توزيع هائلة للثروات.
ومنذ ستة شهور، عندما تصاعدت حركة احتجاجية في منطقة القبائل ضد موازنة 2017، أعلن وزير الداخلية خطة بقيمة 10 مليارات دولار للحفاظ على القوة الشرائية للجزائريين.
ولكن في الوقت الذي يتزايد فيه خواء خزائن الدولة، نفدت الخيارات في أيدي النخبة الحاكمة لاحتواء الاضطراب الاجتماعي،ويملك الجزائريون وفرة من الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالاستياء.
عاصفة
أزمة النفط التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي، والتضخم الذي تلاها كانا عاملين مساهمين في الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك بين الحكومة والجماعات الإسلامية، والتي تسببت في أكثر من 200 ألف قتيل.
كافة المكونات التي أدت إلى حرب أهلية في باكورة التسعينيات تتواجد الآن في الجزائر: أزمة اقتصادية كبرى، وفساد الحزب الحاكم، وتركيز وعظ القيادات الإسلامية على الفساد، وتوترات قبلية ترتبط بالهوية.
وبالفعل، فإن قضايا الهوية تولد عنفا غير مسبوق، خاصة في منطقة القبائل حيث يتم إحياء ميراث الأمازيغ (البربر) كمعارضة للهوية العربية.
وفي ذات الأثناء، فقد تزايد الظهور العام لعلي بلحاج القيادي السابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن فيما يبدو أنه بإذن من السلطات.
ومنذ حوالي شهر، عندما زار بلحاج مسجدا بمنطقة شعبية في العاصمة الجزائر، حظي بترحيب مئات الأشخاص الذين عاملوه معاملة البطل.
أضف إلى ذلك المشكلات الديموغرافية التي تعاني منها الجزائر، إذ أن معظم سكانها من فئة الشباب بمتوسط عمري 27.7 عاما، مما يزيد احتمالات خروج احتجاجات إلى الشوارع، كما أن هذا الجيل الشاب لم يعاصر "العقد الأسود" الذي أعقب الحرب الأهلية السابقة.
الصحة المتدهورة للرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة تمثل أحد العوامل التي تزعزع استقرار الجزائر، حيث أدت إلى صراع سلطة داخل النخبة، وصراعات عشائرية.
اقتتال داخلي مميت؟
ثمة علامات على إمكانية حدوث صراعات عشائرية تتضمن الدائرة الداخلية للرئيس، والأجهزة الأمنية السرية، وقيادات الجيش.
من الضروري تفهم أن النظام الجزائري ينقسم إلى ديكتاتورية عسكرية ودولة بوليسية مع واجهة ديمقراطية تتبدل فيها التحالفات وتتغير بحسب المصالح.
ثمة تحالفات بين التسلسل الهرمي العسكري ودائرة الاستعلام والأمن من جانب، وبين جبهة التحرير الوطني وأصحاب رؤوس الأموال وعائلات النخبة صاحبة النفوذ من جانب آخر.
هذه الجماعات تتعارك على نهب مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية، من خلال جمع عمولات سرية في عقود الاستيراد والتصدير الكبرى.
ويظهر ذلك إلى الضوء من حين إلى آخر، مثل المحاكمة التي تجرى في إيطاليا المتعلقة بعمليات اختلاس ترتبط بمسؤولي سوناطراك.
فترة شديدة المخاطر
خلال خطاب أدلى به في سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي أنه بدءا من نوفمبر فصاعدا، لا تملك الدولة خيارا إلا اللجوء لأساليب تمويل غير تقليدية لدفع أجور الموظفين.
لكنه أيضا شدد على أنه لن يتم تقليص أية دعوم اجتماعية، مع وعد بزيادة المعاشات، وعدم المساس بالضرائب.
ويعني ذلك أن الجزائر سوف تلجأ إلى زيادة القروض، وهي سياسة قد تؤدي إلى زيادة التضخم في السنوات المقبلة وانخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يرتبط بعواقب سلبية على العائلات.